آخـر الأخبـار
- غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
- تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
- الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
- رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
- "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا
- ضمن عملية طوفان الأقصى ..كتائب الناصر تعاود قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية
- طوفان الأقصى : معاودة قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية
- حركة المقاومة الشعبية تنعى القائدين المناضلين عوض السلطان من الجبهة الشعبية وعبد الرحمن شهاب من حركة الجهاد الإسلامي وأفراد عائلاتهم
- نعى قائدين مناضلين /عوض السلطان من الجبهة الشعبية وعبد الرحمن شهاب من حركة الجهاد الإسلامي وأفراد عائلاتهم
- حركة المقاومة الشعبية "محافظة خانيونس" تنعى القائد أسعد البشيتي أمين سر حركة الأحرار في محافظة خانيونس وأفراد عائلته
المقاومة السلمية نظرية دون تطبيق...بقلم : نقولا ناصر

في الحادي عشر من هذا الشهر أقام مناضلون فلسطينيون من أنصار المقاومة السلمية خيام قرية "باب الشمس" فوق هضبة شرقي القدس المحتلة تمثل الممر الوحيد المتبقي للوصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وبين جنوبها، وفي ليل الخميس الماضي هدمتها جرافات الاحتلال بقرار من المحكمة العليا لدولة الاحتلال.
اقـرأ أيـضـــاً
ساريةُ المقاومة خيمةٌ وعمادُها قوةٌ ورمزها وطنٌ ... بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
ساريةُ المقاومة خيمةٌ وعمادُها قوةٌ ورمزها وطنٌ ... بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
-
المصريون يغنون لابنهم محمد صلاح أنا أم البطل ... بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
الإثنين 05 يونيو 2023
-
سياسةُ تسكين الجبهات وتسخين القدس والضفة ... بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
الأربعاء 31 مايو 2023
-
الصحفي الفلسطيني يستحق نقابة حقيقية مؤثرة وليست ديكور ..بقلم: حسن أبو حشيش
الأربعاء 24 مايو 2023
-
بريطانيا في خدمة الاحتلال ... بقلم : نضال محمد وتد
السبت 20 نوفمبر 2021
الخميس 12 أكتوبر 2023
الخميس 12 أكتوبر 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الخميس 12 أكتوبر 2023
الخميس 12 أكتوبر 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023


























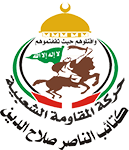
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية