لمى خاطر
منذ أن قرّرت رصد بعد مظاهر الهوس بمتابعة مباريات الدوري الإسباني، وخصوصاً بين فريقي برشلونة وريال مدريد، باتت تنتابني حالة من العجب والأسى وأحياناً الاشمئزاز، سيما وأنني لم أستطع إيجاد ذلك السرّ الكامن خلف (عولمة) هذا الهوس ليعم ويطم المجتمع ووسائل الإعلام، ويغدو حديث طلاب المدارس والجامعات والمجالس العامة، و(جُدر) الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في فلسطين وحسب، ولا في العالم العربي، بل لعله على مستوى العالم أيضا، وبالدرجة الأولى لدى قطاع الشباب!
قد أفهم أن (ينهوس) الشباب والرياضيون بالدوري المحلي، أو حتى بفرق كرة القدم العربية، لكن أن يكون مثل هذا الاصطفاف الحاد، والانقسام في الهوى والتأييد، والسجال والجدل والتحليل، لصالح فرق أوروبية، فهذا مما يضع العقل في الكف كما يقولون! ولكنه عصر العولمة، والتقدم التقني الذي جعل الكون متاحاً على شاشة صغيرة، فلا عجب!
قبل مدة؛ دخلتُ محلاً تجاريا في مدينتي، وسمعت سجالاً حاداً بين اثنين حول شأن ظننته في البداية سياسيا، لأن فيه اتهامات متبادلة بالتعصب وانتفاء الموضوعية وغياب الإنصاف، مع جدية بادية عليهما، ثم تبيّن أنها يتحدثان عن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة! قلت في نفسي: من قال إن شعبنا لا يتعصب إلا في السياسة أو إنه يتنفس سياسة؟ لكن هذه الأخيرة بكل متعلقاتها باتت مظلومة حقا، وهناك من يبالغ في كيل النعوت السبية لها، والتنفير من تعاطيها. ولعل هذا (في جانب منه) نوع من التبرير لتعاطي الأفيون المسمى (كرة القدم)، بدلاً من تذوقها كهواية تشابه غيرها من هوايات أي إنسان. لكنها صارت منذ سنوات شيئاً مقدساً يفوق الهواية ويجاوز المعقول، بعد أن احتلت سلّم أولويات قطاع عريض من جيل الشباب، بل والكبار أيضا، ثم صار هناك من يتخذ لنفسه (معبودا) من أحد الفريقين، لأنه من غير اللائق ألا يحمل جواباً لمن يسأله: (أنت برشلوني أم مدريدي؟)!
المهم أنني اكتشفت أن موعد المباريات يعدّ وقتاً مثالياً لمن يرغب بالخروج من البيت ليسرّي عن نفسه، وخاصة إذا ما كان خالياً من الاهتمامات الرياضية (مثلي) ومحباً للهدوء وكارهاً للضجيج (مثلي أيضا)، إذ جميل أن تجد وقتاً من حين لآخر تخلو فيه الشوارع والأسواق من الازدحام، ومن المتسكعين على الأرصفة، وممن يؤثرون بطبعهم البقاء في الشوارع أو قيادة السيارات وإطلاق العنان لأبواقها بدون سبب!
لكنني ما زلت محتارة بالفعل حول أسباب هذه الظاهرة العامة التي تتجاوز حدود أي مكان، وفيما إذا كان هناك ما يمكن اقتراحه أو عمله للحد منها! أم أنها إحدى تجليات هذه المرحلة من القرن الواحد والعشرين؟ وإن كانت كذلك فسأفهم حتماً لماذا ما زالت نداءات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام –في فلسطين على الأقل- لا تجاوز حناجر مطلقيها، ولا تجد صدى لدى قطاع الشباب، الذين يستسهل
منذ أن قرّرت رصد بعد مظاهر الهوس بمتابعة مباريات الدوري الإسباني، وخصوصاً بين فريقي برشلونة وريال مدريد، باتت تنتابني حالة من العجب والأسى وأحياناً الاشمئزاز، سيما وأنني لم أستطع إيجاد ذلك السرّ الكامن خلف (عولمة) هذا الهوس ليعم ويطم المجتمع ووسائل الإعلام، ويغدو حديث طلاب المدارس والجامعات والمجالس العامة، و(جُدر) الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في فلسطين وحسب، ولا في العالم العربي، بل لعله على مستوى العالم أيضا، وبالدرجة الأولى لدى قطاع الشباب!
قد أفهم أن (ينهوس) الشباب والرياضيون بالدوري المحلي، أو حتى بفرق كرة القدم العربية، لكن أن يكون مثل هذا الاصطفاف الحاد، والانقسام في الهوى والتأييد، والسجال والجدل والتحليل، لصالح فرق أوروبية، فهذا مما يضع العقل في الكف كما يقولون! ولكنه عصر العولمة، والتقدم التقني الذي جعل الكون متاحاً على شاشة صغيرة، فلا عجب!
قبل مدة؛ دخلتُ محلاً تجاريا في مدينتي، وسمعت سجالاً حاداً بين اثنين حول شأن ظننته في البداية سياسيا، لأن فيه اتهامات متبادلة بالتعصب وانتفاء الموضوعية وغياب الإنصاف، مع جدية بادية عليهما، ثم تبيّن أنها يتحدثان عن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة! قلت في نفسي: من قال إن شعبنا لا يتعصب إلا في السياسة أو إنه يتنفس سياسة؟ لكن هذه الأخيرة بكل متعلقاتها باتت مظلومة حقا، وهناك من يبالغ في كيل النعوت السبية لها، والتنفير من تعاطيها. ولعل هذا (في جانب منه) نوع من التبرير لتعاطي الأفيون المسمى (كرة القدم)، بدلاً من تذوقها كهواية تشابه غيرها من هوايات أي إنسان. لكنها صارت منذ سنوات شيئاً مقدساً يفوق الهواية ويجاوز المعقول، بعد أن احتلت سلّم أولويات قطاع عريض من جيل الشباب، بل والكبار أيضا، ثم صار هناك من يتخذ لنفسه (معبودا) من أحد الفريقين، لأنه من غير اللائق ألا يحمل جواباً لمن يسأله: (أنت برشلوني أم مدريدي؟)!
المهم أنني اكتشفت أن موعد المباريات يعدّ وقتاً مثالياً لمن يرغب بالخروج من البيت ليسرّي عن نفسه، وخاصة إذا ما كان خالياً من الاهتمامات الرياضية (مثلي) ومحباً للهدوء وكارهاً للضجيج (مثلي أيضا)، إذ جميل أن تجد وقتاً من حين لآخر تخلو فيه الشوارع والأسواق من الازدحام، ومن المتسكعين على الأرصفة، وممن يؤثرون بطبعهم البقاء في الشوارع أو قيادة السيارات وإطلاق العنان لأبواقها بدون سبب!
لكنني ما زلت محتارة بالفعل حول أسباب هذه الظاهرة العامة التي تتجاوز حدود أي مكان، وفيما إذا كان هناك ما يمكن اقتراحه أو عمله للحد منها! أم أنها إحدى تجليات هذه المرحلة من القرن الواحد والعشرين؟ وإن كانت كذلك فسأفهم حتماً لماذا ما زالت نداءات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام –في فلسطين على الأقل- لا تجاوز حناجر مطلقيها، ولا تجد صدى لدى قطاع الشباب، الذين يستسهل



























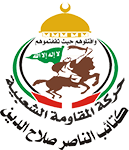
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية