بين جيلين تعب وراحة وبالعكس!
سري سمّور
مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تظهر في بعض منشوراتها صورا للحياة في الزمن الماضي؛ زمن ما قبل الإنترنت والهواتف المحمولة، بل حتى زمن ما قبل انتشار الهواتف الأرضية، ويتحدث كثير من الناس عن الحنين إلى ماض كانت فيه الحياة سهلة وبسيطة، وكان الناس أصفى نفوسا، وكان الشعور بالأمن والأمان طاغيا، ويستذكرون ألعابهم البسيطة جدا، ولكنهم كانوا سعداء بها، وعن دراستهم في ظروف صعبة مثل بعد المدارس وقلة عددها ما اضطر كثيرا من الطلبة للمشي مسافات طويلة في ظروف جوية قاسية، وقلة الكتب التي اضطرتهم إلى نسخ الكتاب الذي بحوزة المعلم بخط اليد-وهو ما جعل خطوطهم جميلة بالمناسبة- ولكنهم كانوا طلبة مجتهدين، يحترمون معلمهم مع أنه كان يقسو عليهم بعصاه التي لا ترحم، وعن اجتماع الأسرة حول كانون النار، وعن (فزعة) الجيران لمساعدة جار عنده (صبة باطون) لغرفة صغيرة أو ما كنا نسميه (قُصة) وهي فناء أمام البيت مخصص للجلوس والضيافة خاصة بعد العصر وليلا في الصيف، وعن أسعار السلع الغذائية الرخيصة نسبيا، وعن طبيب يعرفه كل الناس يعالج كل الأمراض، دون طلب تحاليل طبية ولا صور أشعة، ويكتب الله للمريض الشفاء على يديه، وعن النسوة اللواتي يجتمعن حول الجاروشة الوحيدة في الحي وكل واحدة معها (مونة) أسرتها من العدس أو غيره، وكيف كان ساندويش الفلافل وخبز السوق -الذي يأكله الجميع يوميا حاليا- وكأنه وجبة محترمة فاخرة في فندق درجة أولى، وعن المياه الغازية التي كانت تسمى (كازوز)، وعن السيارات القليلة والباص القديم الذي يتحرك مبكرا ويعود ظهرا...عن معظم صور الحياة التي عاشها مواليد ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.
ويدخل بعض المتحدثين سواء عبر فيسبوك أو بحديث شفوي مباشر في ما يشبه التقريع واللوم للجيل التالي من الأبناء والأحفاد، من أنه جيل كثير التبرم، في حين حياته سهلة وميسرة بفضل التكنولوجيا، وكثرة المدارس والجامعات وقربها وسهولة المواصلات، وكثرة الملابس والأحذية، في حين لجأ الآباء والأجداد إلى الترقيع، وكان نظام كسوة الشتاء وكسوة الصيف هو السائد، وأن الجيل الحالي لديه وفرة وتنوع في الطعام، ويعقدون مقارنات تثبت-من وجهة نظرهم- أن الجيل الحالي مدلل ومنعم ومترف مقارنة بجيل الآباء والأجداد، ومع ذلك فهو جيل يغلب عليه جحود النعم الكثيرة، وتكثر منه الشكوى والتبرّم.
ولمناقشة الموضوع أنا مضطر للنظر إلى الموضوع من زاوية فلسطينية أكثر منها عربية مع أن الأمر ليس مقتصرا علينا معشر الفلسطينيين، ولكن لنا خصوصية لا تخفى على أحد، والسؤال الذي يطرح نفسه:هل فعلا الجيل الجديد وأعني به من ولدوا أواخر ثمانينيات و أوائل تسعينيات القرن الماضي ومن بعدهم في نعيم مقيم مقارنة بآبائهم وأجدادهم، أم أن ثمة أحادية في النظرة إلى الأمور؟
مضطر لأضع نفسي حكما وخيارا وسطا بحكم سني (ولدت في 1974م) فأنا ممن شاهد شاشة التلفزيون بالأبيض والأسود ثم الشاشة الملونة وما بعدها، وأنا ممن تعامل مع الهاتف الأرضي المربوط بالبريد أي أن الاتصال يكون بطلب الرقم من الموظف وليس مباشرة، وأنا ممن لعب بطابة مصنوعة من القماش، وكرة مصنوعة من المطاط في ذات الوقت، وأنا ممن ركب الباص العمومي واقتنى سيارة خاصة به لاحقا، وأنا ممن عاش في بيت الكهرباء فيه متوفرة وكان يرى أنها غير موجودة عند أقاربه في بعض المناطق؛ أي أنني لم أعش مرحلة ستينيات وخمسينيات القرن الماضي وما قبلها وما فيها من أدوات وظروف معيشة نعرفها، فلربما حالة (البين بين) التي حييتها تتيح لي النظر بشمولية إلى الموضوع...أو سأزعم ذلك!
وقبل عقدين من الزمان وحينما شاهد طالب خريج وصل الدفع الخاص بي في أول فصل من دراستي في جامعة النجاح الوطنية قال باستنكار وتعجب:هل تعلم بأنني طوال فترة دراستي في الجامعة لم أتكلف هذا المبلغ الذي ستدفعه أنت في البداية؟! ولا شك أنني وهو لم يخطر في بالنا أنه ستأتي مرحلة يكون فيها الطالب الجامعي بمثابة البلاء على أهله وأسرته، بل صار والد الطالب المتفوق-الذي سيدرس الطب أو الهندسة غالبا- يضيق ذرعا نظرا لما يتكلفه من مصاريف التعليم الجامعي للولد أو البنت ما بين أقساط ومصروفات شخصية ترهق كاهله بالديون، خاصة حينما يكون لديه أكثر من طالبة أو طالبة يدرسون في الجامعة.
وقد رأيت موظفا في صيدلية أثناء أدائي لمناسك العمرة، وعرف من لهجتي أنني فلسطيني مثله، وقد لاحظت أن الرجل كبير السن نسبيا يعمل ساعات طويلة جدا لا يطيقها شاب في مقتبل العمر، فقال بأنه بلغ من العمر 65 سنة، وأنه أفنى شبابه في الغربة، فقلت له أنه آن الأوان كي يرتاح ويعود إلى وطنه ويكفيه من الغربة والتعب ما لاقى، فقال بأنه يتمنى ذلك ولكن لا يستطيع الآن لأن لديه ابن وابنة يدرسون في الجامعات الأردنية، وقد تخرج من أولاده من تخرج فحل هذين محلهما في الدراسة والمصروفات، فتذكرت حالات مشابهة في الغربة أو التعب والنصب أو كلاهما.
لقد صار التعليم الجامعي أشبه بالكابوس، خاصة وأن الثقافة الاجتماعية تغيرت، حيث صار الاهتمام بالتحصيل العلمي شاملا لكل العائلات الأرستقراطية والمتوسطة والفقيرة، وأيضا لا يقتصر على الذكور، بل قد تكون الأنثى عند عائلتها أحق من الذكور، نظرا لتفوقها عادة، فكثير من أوائل الثانوية العامة أو الجامعات في مختلف الكليات من الإناث.
والأدهى والأمر أن الخريجين لم يجدوا من فرص العمل ما وجدنا، ولا ما وجده من قبلنا، فكل جيل تضيق الفرص في وجهه عن الجيل الذي سبقه، ولهذا أسباب كثيرة، منها تطور التكنولوجيا الحديثة وكثرة المتعلمين، وامتلاء القطاعين العام والخاص بالموظفين والعاملين، وأيضا عدم وجود تخطيط صارم يربط بين حاجة سوق العمل وبين دراسة التخصصات المختلفة.
أي أن خريج الجامعة لا تنتهي معاناة أهله بتخرجه، كما كان سابقا، بل سيصاب بالإحباط والكآبة، وهو يفتش عن فرصة عمل تضمن له العيش بشيء من الكرامة، وقلة من يوفقون في هذا الأمر كما نعلم.
وعليه فإن الجيل السابق من الآباء والأجداد وإن كانوا قد عانوا في معيشتهم في بيوت متواضعة وضيقة، أو في دراستهم، إلا أن الفرص كانت متاحة أمامهم، سواء في الوطن أو خارجه، بل سواء كانوا متعلمين أو شبه أميين؛ فقبل حوالي 50 عاما كانت أبواب ما كان يعرف بألمانيا الغربية مفتوحة أمامهم، وقد سافر كثير منهم هناك وعملوا وجمعوا من المال ما ضمن لهم هنا مشروعا صغيرا أو كبيرا يضمن لهم عيشا كريما، واشترى بعضهم أراض أو سيارات وبنوا بيوتا أو وسعوا وحسنوا وأضافوا على بيوتهم، وآخرون وجدوا دول الخليج تفتح لهم أبوابها، فذهبوا هناك، وكم نعرف ممن عمل هناك معلما وهو لم يحصل على أكثر من شهادة الإعدادية أو التوجيهي، ومن كان يحمل الدبلوم كانت فرصته أكبر.
ثم أقفلت ألمانيا أبوابها، وصار الخريجون من أبناء الخليج نفسه يبحثون عن فرص عمل ووظائف، ومع أن ثمة فرص عمل هناك، ولكن العروض حاليا غالبيتها ليست مغرية، وتحتاج إلى خبرات وشهادات علمية متقدمة ومتميزة عما كان سابقا، وبسبب غلاء المعيشة وتقلص فرق العملات، بفعل العولمة فإن الحالة التي كان فيها المغترب في السعودية أو الكويت يتزوج ويزوج إخوته ويبني بيتا جديدا ويضخ لأهله مالا يضمن لهم نوعا من رغد العيش لم تعد موجودة اليوم.
بل لعل الغربة كانت محل انتقاد أحيانا نظرا لأن من يجتهد قد يجد في بلده فرصة ما؛ بعكس الوضع الحالي الذي يضطر بعض الناس إلى الهجرة وطلب اللجوء في دول غربية أو حتى عربية، ويقال والعهدة على الرواي أنه حينما غنت نادية مصطفى أغنية(سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات...ده إن لقيت في الغربة المال فين حتلقى راحة البال...إلخ) وسمعها مغتربون مصريون في العراق عاد عدد منهم على وجه السرعة إلى مصر وطنهم...وفي مصر كنا نرى في المسلسلات ما كان يعرف بنظام (القوى العاملة) وهو نظام حكومي يتيح للخريجين التقدم لوظيفة حكومية، ولا يحتاج إلى واسطة، ولكن قد تأتي الموافقة بعد سنتين فيعين من درس فيزياء نووية من سكان القاهرة موظفا في وزارة الأوقاف مثلا في المنيا، ولكن يكون قد ضمن دخلا ووظيفة حكومية، ولكن حتى هذا النظام على عواره قد ألغي قبل حوالي ربع قرن، وكان للأمر تداعياته المعروفة في مصر.
ولنبق في فلسطين فثمة مقارنات كثيرة؛ فحوالي 850 ألف فلسطيني في الضفة والقطاع تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، وكثير منهم قضوا سنوات وشهور؛ وكان المعتقل ربما يدخل السجن أميا فيخرج يقرأ ويكتب ويحاور في الشأن السياسي والفكري، ومنذ سنين قد يدخل المعتقل السجن ويخرج بعد سنين دون أن يتم قراءة ولو كتاب واحد، وكانت نفسية المفرج عنه عادة تتمتع بقوة وتشعر بأنه صقلت شخصيته، والآن نظرة سريعة تعطيك تصورا عن حالة الأسرى والمحررين عموما، ولك أن تقارنها بالفترات السابقة.
وكان سعر الدخان، ولنكن واقعيين فالتدخين عادة منتشرة عندنا، زهيدا جدا، والآن يضطر المدخنون إلى تدخين سجائر العربي الملفوفة يدويا، وصار من يدخن السجائر العادية يحسب من الطبقة الثرية، أو من المستهترين أو المسرفين والمبذرين!
وعودة إلى الدراسة والتحصيل العلمي، وعلى هامش موضوع أزمة الأونروا فقد كانوا يوزعون علينا قرطاسية من دفاتر وأقلام في مدارس الوكالة تكفينا وتزيد للعام الدراسي التالي، وحدثني موظف سابق في الأونروا أنهم حينما كانوا يعلنون عن وظيفة ما يتقدم لها واحد أو إثنين بينما حاليا مئات الخريجين يهرعون لتقديم طلبات التوظيف.
وفي سياق الحديث عن كثرة حملة الشهادات والدرجات العلمية، لاحظنا أن من لم يكمل سوى المرحلة الإعدادية، أو حتى من تلقى تعلميه عند شيخ الكتاب يكتب بطريقة أفضل من العديد من حملة الماجستير أو الدكتوراه فبعض هؤلاء لا يحسنون الإملاء ويكتبون كلمات شائع استخدامها خطأ، أي أن الكم نما وتضخم على حساب النوع!
وكان هناك انتشار للدراسة شبه المجانية في الداخل والخارج، والعمل مضمون، بل أحد المتقاعدين حدثنا بأنه كان هناك بعض التخصصات خاصة مواد العلوم يشترط فيمن يدرسها أن يعمل مدة معينة في الأردن قبل السماح له بالتوجه إلى الخليج أو غيره، أي كان المطلوب من الطالب فقط الجد والاجتهاد، والحصول على الشهادة، والوظيفة مضمونة ومتوفرة في الأونروا أو الحكومة أو في الخليج، بل حتى من لم يعمل بشهادته كان بمقدوره فتح بيت والعيش بكرامة إذا عمل عتالا أو بائعا على بسطة خضار.
كان بعض من يتقدم للزواج من موظفة أو متعلمة يشترط عليها ألا تعمل وتتفرغ لتكون فقط ربة بيت، وجاء زمان صار الباحث عن زوجة يشترط أن تكون موظفة نظرا لصعوبة وتعقيدات الحياة وغلاء المعيشة المطرد.
كانت حياة السابقين أقسى في بدايتها، ولكنها كانت أسهل وأرخص، حاليا كل شيء يحتاج مالا، ولا يمكن الطلب من الجيل الجديد أن يحيا بدون وسائل العصر، أو كما عشنا أو عاش من قبلنا، والأدهى والأمر أن الأبواب تقريبا موصدة في وجه أبناء وبنات الجيل الجديد.
فعلام نحسد أبناء وبنات اليوم؟على تورطهم في أمور صارت متطلبات حياة ضرورية وكنا نعدها كماليات وهم غير قادرين على توفيرها؟أما على طابور البطالة الذي ينتظرهم؟
وكان الناس –كما هي طبيعة المجتمعات-يختلفون ويتشاجرون ويتضاربون، وكان من يحمل أو يستعمل ما كان يعرف بـ(الموس الكباس ثلاث نجوم) يعتبر وكأنه يحمل سلاحا فتاكا، فجاءنا زمن تستخدم فيه المسدسات والرشاشات الروسية والبنادق الأمريكية في الشجارات التي تقع بين بعض الأشخاص أو العائلات؛ ولعل هذا ما يعتبره الجيل القديم مثلبة ومأخذا على الجيل الجديد من حيث أن الكبار يعتبرون أنفسهم أكثر تسامحا وأنفسهم أكثر خلقا، ولكن سؤالا يطرح نفسه بقوة مع ما فيه من حرج وملح في الجرح:هل التسامح والخلق الحسن مترسخ في النفوس، أم أن القدماء لم يجدوا سوى العصي والحجارة وبعض الآلات الحادة ليتقاتلوا بها، ولو كان في زمانهم أسلحة نارية لما كانوا كما يزعمون؟!
الأمر الذي يمكن أن يفاخر فيه الكبار هو حالة التماسك والتعاضد الوطني؛ فنحن نترحم على زمان كانت رفح تعلن الإضراب على شهداء جنين، وكان ابن جنين حين يلتقي بابن الخليل يذكر له أسماء شهداء الخليل كاملة مع قصص استشهادهم وكأنه يعرفهم عن قرب، وكانت إشاعة عن استشهاد أسير كفيلة بإشعال الشارع، وهو ما كان يضطر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن توصي مصلحة السجون بالتخفيف عن الأسرى، في حين لا تجد اليوم بضع عشرات غالبيتهم من ذوي الأسرى المضربين عن الطعام يقفون وقفة تضامنية، وصار خبر ارتقاء الشهيد يمر كأنه خبر عادي، بل صار أكثر ما يتابعه الشباب بتفاعل وحماسة تثير الدهشة بل التقزز هو مباريات كرة القدم، وبرامج المسابقات الغنائية...ذاك وأمثاله حال يمكن أن يقال أن زمن الكبار فيه مقارنة مع الزمن الحالي(زمن جميل) أما تطور أدوات الحياة والتعليم فقد كان في كثير من جوانبه ابتلاء وحِملا زائدا ليس إلا...كان الله في عون أبناء الجيل الجديد، فإن حياتهم أصعب وأكثر تعقيدا وإن بدت في عيننا عكس ذلك.
سري سمّور
مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تظهر في بعض منشوراتها صورا للحياة في الزمن الماضي؛ زمن ما قبل الإنترنت والهواتف المحمولة، بل حتى زمن ما قبل انتشار الهواتف الأرضية، ويتحدث كثير من الناس عن الحنين إلى ماض كانت فيه الحياة سهلة وبسيطة، وكان الناس أصفى نفوسا، وكان الشعور بالأمن والأمان طاغيا، ويستذكرون ألعابهم البسيطة جدا، ولكنهم كانوا سعداء بها، وعن دراستهم في ظروف صعبة مثل بعد المدارس وقلة عددها ما اضطر كثيرا من الطلبة للمشي مسافات طويلة في ظروف جوية قاسية، وقلة الكتب التي اضطرتهم إلى نسخ الكتاب الذي بحوزة المعلم بخط اليد-وهو ما جعل خطوطهم جميلة بالمناسبة- ولكنهم كانوا طلبة مجتهدين، يحترمون معلمهم مع أنه كان يقسو عليهم بعصاه التي لا ترحم، وعن اجتماع الأسرة حول كانون النار، وعن (فزعة) الجيران لمساعدة جار عنده (صبة باطون) لغرفة صغيرة أو ما كنا نسميه (قُصة) وهي فناء أمام البيت مخصص للجلوس والضيافة خاصة بعد العصر وليلا في الصيف، وعن أسعار السلع الغذائية الرخيصة نسبيا، وعن طبيب يعرفه كل الناس يعالج كل الأمراض، دون طلب تحاليل طبية ولا صور أشعة، ويكتب الله للمريض الشفاء على يديه، وعن النسوة اللواتي يجتمعن حول الجاروشة الوحيدة في الحي وكل واحدة معها (مونة) أسرتها من العدس أو غيره، وكيف كان ساندويش الفلافل وخبز السوق -الذي يأكله الجميع يوميا حاليا- وكأنه وجبة محترمة فاخرة في فندق درجة أولى، وعن المياه الغازية التي كانت تسمى (كازوز)، وعن السيارات القليلة والباص القديم الذي يتحرك مبكرا ويعود ظهرا...عن معظم صور الحياة التي عاشها مواليد ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.
ويدخل بعض المتحدثين سواء عبر فيسبوك أو بحديث شفوي مباشر في ما يشبه التقريع واللوم للجيل التالي من الأبناء والأحفاد، من أنه جيل كثير التبرم، في حين حياته سهلة وميسرة بفضل التكنولوجيا، وكثرة المدارس والجامعات وقربها وسهولة المواصلات، وكثرة الملابس والأحذية، في حين لجأ الآباء والأجداد إلى الترقيع، وكان نظام كسوة الشتاء وكسوة الصيف هو السائد، وأن الجيل الحالي لديه وفرة وتنوع في الطعام، ويعقدون مقارنات تثبت-من وجهة نظرهم- أن الجيل الحالي مدلل ومنعم ومترف مقارنة بجيل الآباء والأجداد، ومع ذلك فهو جيل يغلب عليه جحود النعم الكثيرة، وتكثر منه الشكوى والتبرّم.
ولمناقشة الموضوع أنا مضطر للنظر إلى الموضوع من زاوية فلسطينية أكثر منها عربية مع أن الأمر ليس مقتصرا علينا معشر الفلسطينيين، ولكن لنا خصوصية لا تخفى على أحد، والسؤال الذي يطرح نفسه:هل فعلا الجيل الجديد وأعني به من ولدوا أواخر ثمانينيات و أوائل تسعينيات القرن الماضي ومن بعدهم في نعيم مقيم مقارنة بآبائهم وأجدادهم، أم أن ثمة أحادية في النظرة إلى الأمور؟
مضطر لأضع نفسي حكما وخيارا وسطا بحكم سني (ولدت في 1974م) فأنا ممن شاهد شاشة التلفزيون بالأبيض والأسود ثم الشاشة الملونة وما بعدها، وأنا ممن تعامل مع الهاتف الأرضي المربوط بالبريد أي أن الاتصال يكون بطلب الرقم من الموظف وليس مباشرة، وأنا ممن لعب بطابة مصنوعة من القماش، وكرة مصنوعة من المطاط في ذات الوقت، وأنا ممن ركب الباص العمومي واقتنى سيارة خاصة به لاحقا، وأنا ممن عاش في بيت الكهرباء فيه متوفرة وكان يرى أنها غير موجودة عند أقاربه في بعض المناطق؛ أي أنني لم أعش مرحلة ستينيات وخمسينيات القرن الماضي وما قبلها وما فيها من أدوات وظروف معيشة نعرفها، فلربما حالة (البين بين) التي حييتها تتيح لي النظر بشمولية إلى الموضوع...أو سأزعم ذلك!
وقبل عقدين من الزمان وحينما شاهد طالب خريج وصل الدفع الخاص بي في أول فصل من دراستي في جامعة النجاح الوطنية قال باستنكار وتعجب:هل تعلم بأنني طوال فترة دراستي في الجامعة لم أتكلف هذا المبلغ الذي ستدفعه أنت في البداية؟! ولا شك أنني وهو لم يخطر في بالنا أنه ستأتي مرحلة يكون فيها الطالب الجامعي بمثابة البلاء على أهله وأسرته، بل صار والد الطالب المتفوق-الذي سيدرس الطب أو الهندسة غالبا- يضيق ذرعا نظرا لما يتكلفه من مصاريف التعليم الجامعي للولد أو البنت ما بين أقساط ومصروفات شخصية ترهق كاهله بالديون، خاصة حينما يكون لديه أكثر من طالبة أو طالبة يدرسون في الجامعة.
وقد رأيت موظفا في صيدلية أثناء أدائي لمناسك العمرة، وعرف من لهجتي أنني فلسطيني مثله، وقد لاحظت أن الرجل كبير السن نسبيا يعمل ساعات طويلة جدا لا يطيقها شاب في مقتبل العمر، فقال بأنه بلغ من العمر 65 سنة، وأنه أفنى شبابه في الغربة، فقلت له أنه آن الأوان كي يرتاح ويعود إلى وطنه ويكفيه من الغربة والتعب ما لاقى، فقال بأنه يتمنى ذلك ولكن لا يستطيع الآن لأن لديه ابن وابنة يدرسون في الجامعات الأردنية، وقد تخرج من أولاده من تخرج فحل هذين محلهما في الدراسة والمصروفات، فتذكرت حالات مشابهة في الغربة أو التعب والنصب أو كلاهما.
لقد صار التعليم الجامعي أشبه بالكابوس، خاصة وأن الثقافة الاجتماعية تغيرت، حيث صار الاهتمام بالتحصيل العلمي شاملا لكل العائلات الأرستقراطية والمتوسطة والفقيرة، وأيضا لا يقتصر على الذكور، بل قد تكون الأنثى عند عائلتها أحق من الذكور، نظرا لتفوقها عادة، فكثير من أوائل الثانوية العامة أو الجامعات في مختلف الكليات من الإناث.
والأدهى والأمر أن الخريجين لم يجدوا من فرص العمل ما وجدنا، ولا ما وجده من قبلنا، فكل جيل تضيق الفرص في وجهه عن الجيل الذي سبقه، ولهذا أسباب كثيرة، منها تطور التكنولوجيا الحديثة وكثرة المتعلمين، وامتلاء القطاعين العام والخاص بالموظفين والعاملين، وأيضا عدم وجود تخطيط صارم يربط بين حاجة سوق العمل وبين دراسة التخصصات المختلفة.
أي أن خريج الجامعة لا تنتهي معاناة أهله بتخرجه، كما كان سابقا، بل سيصاب بالإحباط والكآبة، وهو يفتش عن فرصة عمل تضمن له العيش بشيء من الكرامة، وقلة من يوفقون في هذا الأمر كما نعلم.
وعليه فإن الجيل السابق من الآباء والأجداد وإن كانوا قد عانوا في معيشتهم في بيوت متواضعة وضيقة، أو في دراستهم، إلا أن الفرص كانت متاحة أمامهم، سواء في الوطن أو خارجه، بل سواء كانوا متعلمين أو شبه أميين؛ فقبل حوالي 50 عاما كانت أبواب ما كان يعرف بألمانيا الغربية مفتوحة أمامهم، وقد سافر كثير منهم هناك وعملوا وجمعوا من المال ما ضمن لهم هنا مشروعا صغيرا أو كبيرا يضمن لهم عيشا كريما، واشترى بعضهم أراض أو سيارات وبنوا بيوتا أو وسعوا وحسنوا وأضافوا على بيوتهم، وآخرون وجدوا دول الخليج تفتح لهم أبوابها، فذهبوا هناك، وكم نعرف ممن عمل هناك معلما وهو لم يحصل على أكثر من شهادة الإعدادية أو التوجيهي، ومن كان يحمل الدبلوم كانت فرصته أكبر.
ثم أقفلت ألمانيا أبوابها، وصار الخريجون من أبناء الخليج نفسه يبحثون عن فرص عمل ووظائف، ومع أن ثمة فرص عمل هناك، ولكن العروض حاليا غالبيتها ليست مغرية، وتحتاج إلى خبرات وشهادات علمية متقدمة ومتميزة عما كان سابقا، وبسبب غلاء المعيشة وتقلص فرق العملات، بفعل العولمة فإن الحالة التي كان فيها المغترب في السعودية أو الكويت يتزوج ويزوج إخوته ويبني بيتا جديدا ويضخ لأهله مالا يضمن لهم نوعا من رغد العيش لم تعد موجودة اليوم.
بل لعل الغربة كانت محل انتقاد أحيانا نظرا لأن من يجتهد قد يجد في بلده فرصة ما؛ بعكس الوضع الحالي الذي يضطر بعض الناس إلى الهجرة وطلب اللجوء في دول غربية أو حتى عربية، ويقال والعهدة على الرواي أنه حينما غنت نادية مصطفى أغنية(سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات...ده إن لقيت في الغربة المال فين حتلقى راحة البال...إلخ) وسمعها مغتربون مصريون في العراق عاد عدد منهم على وجه السرعة إلى مصر وطنهم...وفي مصر كنا نرى في المسلسلات ما كان يعرف بنظام (القوى العاملة) وهو نظام حكومي يتيح للخريجين التقدم لوظيفة حكومية، ولا يحتاج إلى واسطة، ولكن قد تأتي الموافقة بعد سنتين فيعين من درس فيزياء نووية من سكان القاهرة موظفا في وزارة الأوقاف مثلا في المنيا، ولكن يكون قد ضمن دخلا ووظيفة حكومية، ولكن حتى هذا النظام على عواره قد ألغي قبل حوالي ربع قرن، وكان للأمر تداعياته المعروفة في مصر.
ولنبق في فلسطين فثمة مقارنات كثيرة؛ فحوالي 850 ألف فلسطيني في الضفة والقطاع تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، وكثير منهم قضوا سنوات وشهور؛ وكان المعتقل ربما يدخل السجن أميا فيخرج يقرأ ويكتب ويحاور في الشأن السياسي والفكري، ومنذ سنين قد يدخل المعتقل السجن ويخرج بعد سنين دون أن يتم قراءة ولو كتاب واحد، وكانت نفسية المفرج عنه عادة تتمتع بقوة وتشعر بأنه صقلت شخصيته، والآن نظرة سريعة تعطيك تصورا عن حالة الأسرى والمحررين عموما، ولك أن تقارنها بالفترات السابقة.
وكان سعر الدخان، ولنكن واقعيين فالتدخين عادة منتشرة عندنا، زهيدا جدا، والآن يضطر المدخنون إلى تدخين سجائر العربي الملفوفة يدويا، وصار من يدخن السجائر العادية يحسب من الطبقة الثرية، أو من المستهترين أو المسرفين والمبذرين!
وعودة إلى الدراسة والتحصيل العلمي، وعلى هامش موضوع أزمة الأونروا فقد كانوا يوزعون علينا قرطاسية من دفاتر وأقلام في مدارس الوكالة تكفينا وتزيد للعام الدراسي التالي، وحدثني موظف سابق في الأونروا أنهم حينما كانوا يعلنون عن وظيفة ما يتقدم لها واحد أو إثنين بينما حاليا مئات الخريجين يهرعون لتقديم طلبات التوظيف.
وفي سياق الحديث عن كثرة حملة الشهادات والدرجات العلمية، لاحظنا أن من لم يكمل سوى المرحلة الإعدادية، أو حتى من تلقى تعلميه عند شيخ الكتاب يكتب بطريقة أفضل من العديد من حملة الماجستير أو الدكتوراه فبعض هؤلاء لا يحسنون الإملاء ويكتبون كلمات شائع استخدامها خطأ، أي أن الكم نما وتضخم على حساب النوع!
وكان هناك انتشار للدراسة شبه المجانية في الداخل والخارج، والعمل مضمون، بل أحد المتقاعدين حدثنا بأنه كان هناك بعض التخصصات خاصة مواد العلوم يشترط فيمن يدرسها أن يعمل مدة معينة في الأردن قبل السماح له بالتوجه إلى الخليج أو غيره، أي كان المطلوب من الطالب فقط الجد والاجتهاد، والحصول على الشهادة، والوظيفة مضمونة ومتوفرة في الأونروا أو الحكومة أو في الخليج، بل حتى من لم يعمل بشهادته كان بمقدوره فتح بيت والعيش بكرامة إذا عمل عتالا أو بائعا على بسطة خضار.
كان بعض من يتقدم للزواج من موظفة أو متعلمة يشترط عليها ألا تعمل وتتفرغ لتكون فقط ربة بيت، وجاء زمان صار الباحث عن زوجة يشترط أن تكون موظفة نظرا لصعوبة وتعقيدات الحياة وغلاء المعيشة المطرد.
كانت حياة السابقين أقسى في بدايتها، ولكنها كانت أسهل وأرخص، حاليا كل شيء يحتاج مالا، ولا يمكن الطلب من الجيل الجديد أن يحيا بدون وسائل العصر، أو كما عشنا أو عاش من قبلنا، والأدهى والأمر أن الأبواب تقريبا موصدة في وجه أبناء وبنات الجيل الجديد.
فعلام نحسد أبناء وبنات اليوم؟على تورطهم في أمور صارت متطلبات حياة ضرورية وكنا نعدها كماليات وهم غير قادرين على توفيرها؟أما على طابور البطالة الذي ينتظرهم؟
وكان الناس –كما هي طبيعة المجتمعات-يختلفون ويتشاجرون ويتضاربون، وكان من يحمل أو يستعمل ما كان يعرف بـ(الموس الكباس ثلاث نجوم) يعتبر وكأنه يحمل سلاحا فتاكا، فجاءنا زمن تستخدم فيه المسدسات والرشاشات الروسية والبنادق الأمريكية في الشجارات التي تقع بين بعض الأشخاص أو العائلات؛ ولعل هذا ما يعتبره الجيل القديم مثلبة ومأخذا على الجيل الجديد من حيث أن الكبار يعتبرون أنفسهم أكثر تسامحا وأنفسهم أكثر خلقا، ولكن سؤالا يطرح نفسه بقوة مع ما فيه من حرج وملح في الجرح:هل التسامح والخلق الحسن مترسخ في النفوس، أم أن القدماء لم يجدوا سوى العصي والحجارة وبعض الآلات الحادة ليتقاتلوا بها، ولو كان في زمانهم أسلحة نارية لما كانوا كما يزعمون؟!
الأمر الذي يمكن أن يفاخر فيه الكبار هو حالة التماسك والتعاضد الوطني؛ فنحن نترحم على زمان كانت رفح تعلن الإضراب على شهداء جنين، وكان ابن جنين حين يلتقي بابن الخليل يذكر له أسماء شهداء الخليل كاملة مع قصص استشهادهم وكأنه يعرفهم عن قرب، وكانت إشاعة عن استشهاد أسير كفيلة بإشعال الشارع، وهو ما كان يضطر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن توصي مصلحة السجون بالتخفيف عن الأسرى، في حين لا تجد اليوم بضع عشرات غالبيتهم من ذوي الأسرى المضربين عن الطعام يقفون وقفة تضامنية، وصار خبر ارتقاء الشهيد يمر كأنه خبر عادي، بل صار أكثر ما يتابعه الشباب بتفاعل وحماسة تثير الدهشة بل التقزز هو مباريات كرة القدم، وبرامج المسابقات الغنائية...ذاك وأمثاله حال يمكن أن يقال أن زمن الكبار فيه مقارنة مع الزمن الحالي(زمن جميل) أما تطور أدوات الحياة والتعليم فقد كان في كثير من جوانبه ابتلاء وحِملا زائدا ليس إلا...كان الله في عون أبناء الجيل الجديد، فإن حياتهم أصعب وأكثر تعقيدا وإن بدت في عيننا عكس ذلك.



























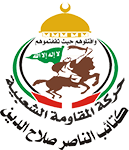
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية