ماذا سنخسر إن فشلت المصالحة؟
مسلم عمران أبو عمر
الناظر في حال القضية الفلسطينية اليوم يدرك أنها برمتها –أرضا وشعبا ومشروعا وطنيا-تمر بإحدى أشد مراحلها خطورة وحساسية. ففلسطين تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، قد لا يختلف كثيرا عن ذاك الذي مرت به أثناء وقوع النكبة قبل 67 عاما. ولئن لم يتداركها المخلصون من أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني على عجل، فإنها توشك أن تنزلق إلى مهاوي نكبة أخرى جديدة، ولعل جوهر الخطر هنا يكمن في تطاول زمن الانقسام. وما اتفاقية المصالحة الأخيرة الموقعة في غزة إلا بارقة أمل جديدة ومحاولة متأخرة لإنقاذ القضية الفلسطينية من مستقبل مجهول، ولكن أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي!
ورغم أنه من بالغ الأهمية والحكمة أن تدرس مسألة الانقسام الوطني الفلسطيني بتجرد، أسبابها وحيثياتها وآثارها وسبل علاجها. إلا أن هذا المقال لا يسعى إلى دراسة هذه القضايا على أهميتها، بل هو محاولة لتسليط الضوء على مخاطر استمرار الانقسام، وآثاره السلبية على القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني.
أولى مخاطر وسلبيات استمرار الانقسام الفلسطيني هي استفحال تكلس وجمود النخب القيادية صانعة القرار -شخوصا وهياكلَ وأفكارا-. والسبب الأبرز في ذلك هو ضعف أو انعدام الديمقراطية الداخلية حزبيا ووطنيا -ثقافتها وممارستها-لدى كثير من مؤسسات وفصائل العمل الوطني.
فاستمرار الانقسام بما يعنيه من تعطيل لعملية الإصلاح الوطني وتأخير لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واستمرار لتهميش معظم قطاعات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده -داخل الوطن المحتل وخارجه-يعني بالضرورة تكريس تفرد مجموعة محدودة من صناع القرار -قد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين-في توجيه دفة القضية الفلسطينية نحو المجهول. ولو أحسنا الظن بهذه المجموعة القيادية -المحدودة العدد والعدة-وجزمنا بأن ما يحركها هو المصالح الوطنية العليا، لا المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة، فإن هذا لا يكسبها الشرعية القانونية -أو حتى المعنوية-اللازمة لقيادة شعب عريق صاحب قضية عادلة؛ فمحدودية تمثيل هذه النخب القيادية لأطياف الشعب الفلسطيني المتعددة، وضعف أو انقطاع تواصلها مع جماهير وقطاعات شعبها المختلفة يعني أن هذه النخب أصبحت عاجزة عن تقديم أو قيادة مشروع وطني يعبر عن الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.
هذه النخب القيادية -التي استمرت في قيادة الشعب الفلسطيني عقودا طوالا دون رقيب أو حسيب-لم تعد قادرة اليوم على الصمود في وجه أية ضغوط خارجية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية، وهي تفتقر للمساندة الشعبية التي لا غنى لقائد عنها، خصوصا في عصر صحوة الشعوب، فضلا عن افتقارها أصلا لأسباب القوة المادية في ظل انكماش المقاومة وغياب القدرة -أو الإرادة-الرسمية على توظيفها في خدمة المشروع الوطني؟!
إن استمرار الانقسام لا يخدم إلا العدو، ومصالح نخب قيادية محدودة عاجزة عن التجديد، فضلا عن حيلولته دون تقدم أجيال قيادية جديدة تحتاجها القضية اليوم أكثر من أي وقت فائت!
ثاني مخاطر استمرار الانقسام هو تكريس واقع محلي جديد لا يخدم إلا السعي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية! وليس هذا الواقع جغرافيا فحسب -كما قد يظن البعض- بل هو واقع مؤسساتي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد بدأت آثاره السلبية بالظهور.
فالمتابع لتطورات الواقع الفلسطيني يلحظ أن الاحتلال الصهيوني قد سعى خلال سنوات الاحتلال لخلق حالة انقسام معنوي بين شرائح المجتمع الفلسطيني؛ فميز بين فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967، ثم بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات ثم بين فلسطينيي الضفة وفلسطينيي القدس، ثم بين فلسطينيي ال1948 المسلمين وإخوانهم المسيحيين، والقائمة تطول. والخشية هنا ليست من أي انقسام معنوي يفرضه الاحتلال، فالاحتلال إلى زوال وسياساته عادة ما تلقى ممانعة نفسية واجتماعية فلسطينية تبطل مفعولها، ولكن الخشية من الانقسام الذي يكون للفلسطينيين أنفسهم دور في تحققه! فالانقسام الحاصل الآن بين الضفة وغزة -وحرص الاحتلال على استمراره وتعقيده عبر فرض الحصار على غزة ومنع سبل التواصل بينها وبين الضفة- لا يبشر بخير أبدا، وأول أخطاره أنه قد يفرز انقساما معنويا جديدا لن يلبث أن يستفحل أمره ما لم تبذل جهود واعية ومخلصة لمقاومة ذلك. ولعل بروز توصيفات مناطقية، للتعبير عن مناطق من فلسطين في مقام التعبير عن فلسطين ككل، شاهد على خطورة هذا الأمر. فكما نجح الاحتلال –مستفيدا من أوسلو- بترويج مسمى "المناطق الفلسطينية" للتعبير عن "فلسطين" فها هو الانقسام يدفع بمصطلحات من قبيل "الشعب الغزي" أو "الشعب الضفاوي" للظهور في سياقات ينبغي التعبير فيها عن الكل بدل الجزء.
أما ثالث المخاطر التي يجلبها استمرار الانقسام فهو توفير الانقسام فرصة تاريخية للعدو الصهيوني لتثبيت أركانه وتدعيم بنيانه لأجيال قادمة بسبب الوهن الفلسطيني الناجم عن الانقسام.
ورغم أن نظريات كثيرة تجزم بأن المشروع الصهيوني يحمل بذور فشله في داخله، وأنه سائر إلى زوال، لاستحالة نجاح أي استعمار إحلالي في البقاء في ظل فشله باستئصال وتصفية السكان الأصليين كما في حالتي جنوب إفريقيا والجزائر. إلا أن هذا لا يعني إمكانية إجهاض هذا المشروع في ظل واقع فلسطيني ضعيف. فكما نجح الاستعمار الأبيض في جنوب إفريقيا في تثبيت أركان حكمه أربعة قرون -بسبب ضعف وتشرذم أصحاب الأرض الأصليين-فإن الاحتلال الصهيوني قد يستمر ويمتد لأجيال قادمة إن لم تجتمع كلمة الفلسطينيين ومن خلفهم ظهيرهم العربي والإسلامي على مواجهة هذا الاستعمار الصهيوني الإحلالي. ولعل في تذكر الإمارات الصليبية في المشرق العربي فائدة؛ فقد امتد عمر بعضها في الشام إلى قرابة القرنين، بينما نجح الاستعمار الأسباني بطرد العرب المسلمين من الأندلس إلى الأبد، ولم يتحقق ذلك إلا لضعف وتشرذم أهل الشام والأندلس.
ولئن كنا نؤمن بحتمية تحرير المسجد الأقصى المبارك وعودة فلسطين إلى حضن أمتها فهذا لا يعني بالضرورة أن من سيحررها هو هذا الجيل! فلكي ينالَ هذا الجيل شرف تحرير هذه الأرض المباركة فإن أولى المهام هي توحيد الصف ولم الشمل واجتماع الكلمة، وما المصالحة الوطنية الفلسطينية إلا خطوة أولى على هذا الطريق الطويل.
ومن المشاهد الملموسة أن سنوات الانقسام قد أتاحت للعدو الصهيوني فرصة ذهبية لتوسيع استيطانه في الضفة وتعزيز حصاره لغزة وتفعيل مشاريعه لتهويد القدس والمسجد الأقصى ومضاعفة جهوده لترحيل فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر ممارسات عنصرية قد لا يكون آخرها "مشروع برافر"، ومشروع تصنيف مسيحيي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 فئة غير عربية وغير فلسطينية داخل الكيان المحتل. كل هذه الممارسات والسياسات ساهمت في خلق واقع جديد على الأرض أضعف الجانب الفلسطيني -المفاوض والمقاوم على حد سواء -وما كان هذا ليتحقق لولا تمادي الانقسام الفلسطيني والتشرذم الوطني. ولنتأمل جيداً لو أن كثيرًا من تلك الجهود الإعلامية والسياسية والأمنية الفلسطينية التي بذلت داخليا لمواجهة الطرف الفلسطيني الآخر عبر سنوات الانقسام قد بذلت حصرا في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفقا لتوافق وطني، فأي حال كانت ستكون عليه قضيتنا الوطنية اليوم؟! بلا شك أنه كان سيكون واقعا أفضل مما نحن عليه الآن! فالواقع الذي عشناه عبر سني الانقسام شهد تبدد الكثير من الإنجازات الوطنية الكبرى -العسكرية والدبلوماسية والشعبية-بسبب ضعف التنسيق الوطني أو غيابه.
هذا الواقع المؤلم، بجعلنا نفكر بعمق بالأثر الكبير التي كانت ستحققه إنجازات وطنية -حصلت في عهد الانقسام -لمشروعنا الوطني مثل صفقة وفاء الأحرار، والصمود في معركتي الفرقان والسجيل، والحصول على اعتراف أممي بفلسطين، والنجاح في إجهاض مشروع برافر، لو كان الصف الوطني موحدا؟! لقد كانت هذه الإنجازات الوطنية الكبرى إضافات نوعيه للنضال الفلسطيني، ولكنها كانت ستضيف أكثر لو أنها جرت في ظل توافق وطني.
أما رابع الآثار السلبية للاتقسام فهو استمرار خسارة القضية الفلسطينية لكم هائل من الدعم الدولي والإقليمي، الرسمي والشعبي بسبب -أو ربما بذريعة- الانقسام!
تكمن المشكلة هنا -في ظل الانقسام-بواقع تفرق وتشتت هذا الدعم الخارجي، فبدل أن يصب في صلب مشروع وطني موحد واضح المعالم يعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني، فإنه يصب في كل الاتجاهات، مما يؤخر من تحويل النضال الفلسطيني إلى سيل عرم متدفق متصل قادر على استئصال شأفة الاحتلال الصهيوني مرة وللأبد. أليس من حقائق الفيزياء أن ضغط السائل إن توزع ضعف أثره، وإن تركز في بؤرة واحدة اشتد أثره وعظم فعله؟
إن تحقيق توافق وطني فلسطيني على مشروع وطني موحد واضح المعالم سيجعل من أي موقف سياسي داعم أو مبلغ مالي مساند أو مشروع شعبي مؤيد، سيجعل منهم أضعافا مضاعفة بإذن الله تشد عضد الشعب الفلسطيني في نضاله وتؤثر على مراكز القوى في العالم بأسره لإيقاف جريمة الاحتلال وإعادة الحق الفلسطيني السليب.
يذكر "إيلان بابه" أحد أهم المؤرخين "الإسرائيليين" الجدد في كتابه المهم "التطهير العرقي في فلسطين" أن العصابات الصهيونية نجحت في إقامة كيانها المحتل على الأرض الفلسطينية عبر عمليات تطهير عرقي منظمة فشل الفلسطينيون ومن ساندهم من العرب -آنذاك-في إيقافها والدفاع عن وجودهم على أرضهم. ويشير إلى أن أحد أهم أسباب العجز الفلسطيني آنذاك كان ضعف بل وغياب القيادة، حيث نجح الانتداب البريطاني -الخائن-بضرب الحركة الوطنية الفلسطينية التي استنزفتها ثورة 1936 مما سهل على الميليشيات الصهيونية، الأكثر تنظيما والأفضل تسليحا وتدريبا، أن تبني كيانها على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية، ويعبر عن هذا الحال بقوله: "كان المجتمع الفلسطيني -من جميع النواحي-شعبا بلا قيادة!".
أما اليوم، وقد مضى على النكبة 66 عاما، وقد أصبح للشعب الفلسطيني فصائله ومؤسساته وقياداته وتاريخه النضالي العريق، فلا يصح أن ننتقل من أزمة غياب القيادة إلى أزمة انقسام القيادة! آن لشعبنا الفلسطيني أن يتوحد صفه القيادي وتعود مؤسساته الوطنية إلى تكثيف الجهود لتحرير الأرض والمقدسات ولعودة أصحاب الأرض الأصليين إلى ديارهم، وما لم يتم هذا التوحد؛ فأبشر -لا قدر الله- بطول سلامة يا احتلال!!
* تنويه: بعض أفكار هذا المقال مستقاة من كتاب "إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية" لجميل هلال.
مسلم عمران أبو عمر
الناظر في حال القضية الفلسطينية اليوم يدرك أنها برمتها –أرضا وشعبا ومشروعا وطنيا-تمر بإحدى أشد مراحلها خطورة وحساسية. ففلسطين تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، قد لا يختلف كثيرا عن ذاك الذي مرت به أثناء وقوع النكبة قبل 67 عاما. ولئن لم يتداركها المخلصون من أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني على عجل، فإنها توشك أن تنزلق إلى مهاوي نكبة أخرى جديدة، ولعل جوهر الخطر هنا يكمن في تطاول زمن الانقسام. وما اتفاقية المصالحة الأخيرة الموقعة في غزة إلا بارقة أمل جديدة ومحاولة متأخرة لإنقاذ القضية الفلسطينية من مستقبل مجهول، ولكن أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي!
ورغم أنه من بالغ الأهمية والحكمة أن تدرس مسألة الانقسام الوطني الفلسطيني بتجرد، أسبابها وحيثياتها وآثارها وسبل علاجها. إلا أن هذا المقال لا يسعى إلى دراسة هذه القضايا على أهميتها، بل هو محاولة لتسليط الضوء على مخاطر استمرار الانقسام، وآثاره السلبية على القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني.
أولى مخاطر وسلبيات استمرار الانقسام الفلسطيني هي استفحال تكلس وجمود النخب القيادية صانعة القرار -شخوصا وهياكلَ وأفكارا-. والسبب الأبرز في ذلك هو ضعف أو انعدام الديمقراطية الداخلية حزبيا ووطنيا -ثقافتها وممارستها-لدى كثير من مؤسسات وفصائل العمل الوطني.
فاستمرار الانقسام بما يعنيه من تعطيل لعملية الإصلاح الوطني وتأخير لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واستمرار لتهميش معظم قطاعات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده -داخل الوطن المحتل وخارجه-يعني بالضرورة تكريس تفرد مجموعة محدودة من صناع القرار -قد لا تتجاوز عدد أصابع اليدين-في توجيه دفة القضية الفلسطينية نحو المجهول. ولو أحسنا الظن بهذه المجموعة القيادية -المحدودة العدد والعدة-وجزمنا بأن ما يحركها هو المصالح الوطنية العليا، لا المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة، فإن هذا لا يكسبها الشرعية القانونية -أو حتى المعنوية-اللازمة لقيادة شعب عريق صاحب قضية عادلة؛ فمحدودية تمثيل هذه النخب القيادية لأطياف الشعب الفلسطيني المتعددة، وضعف أو انقطاع تواصلها مع جماهير وقطاعات شعبها المختلفة يعني أن هذه النخب أصبحت عاجزة عن تقديم أو قيادة مشروع وطني يعبر عن الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.
هذه النخب القيادية -التي استمرت في قيادة الشعب الفلسطيني عقودا طوالا دون رقيب أو حسيب-لم تعد قادرة اليوم على الصمود في وجه أية ضغوط خارجية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية، وهي تفتقر للمساندة الشعبية التي لا غنى لقائد عنها، خصوصا في عصر صحوة الشعوب، فضلا عن افتقارها أصلا لأسباب القوة المادية في ظل انكماش المقاومة وغياب القدرة -أو الإرادة-الرسمية على توظيفها في خدمة المشروع الوطني؟!
إن استمرار الانقسام لا يخدم إلا العدو، ومصالح نخب قيادية محدودة عاجزة عن التجديد، فضلا عن حيلولته دون تقدم أجيال قيادية جديدة تحتاجها القضية اليوم أكثر من أي وقت فائت!
ثاني مخاطر استمرار الانقسام هو تكريس واقع محلي جديد لا يخدم إلا السعي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية! وليس هذا الواقع جغرافيا فحسب -كما قد يظن البعض- بل هو واقع مؤسساتي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد بدأت آثاره السلبية بالظهور.
فالمتابع لتطورات الواقع الفلسطيني يلحظ أن الاحتلال الصهيوني قد سعى خلال سنوات الاحتلال لخلق حالة انقسام معنوي بين شرائح المجتمع الفلسطيني؛ فميز بين فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967، ثم بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات ثم بين فلسطينيي الضفة وفلسطينيي القدس، ثم بين فلسطينيي ال1948 المسلمين وإخوانهم المسيحيين، والقائمة تطول. والخشية هنا ليست من أي انقسام معنوي يفرضه الاحتلال، فالاحتلال إلى زوال وسياساته عادة ما تلقى ممانعة نفسية واجتماعية فلسطينية تبطل مفعولها، ولكن الخشية من الانقسام الذي يكون للفلسطينيين أنفسهم دور في تحققه! فالانقسام الحاصل الآن بين الضفة وغزة -وحرص الاحتلال على استمراره وتعقيده عبر فرض الحصار على غزة ومنع سبل التواصل بينها وبين الضفة- لا يبشر بخير أبدا، وأول أخطاره أنه قد يفرز انقساما معنويا جديدا لن يلبث أن يستفحل أمره ما لم تبذل جهود واعية ومخلصة لمقاومة ذلك. ولعل بروز توصيفات مناطقية، للتعبير عن مناطق من فلسطين في مقام التعبير عن فلسطين ككل، شاهد على خطورة هذا الأمر. فكما نجح الاحتلال –مستفيدا من أوسلو- بترويج مسمى "المناطق الفلسطينية" للتعبير عن "فلسطين" فها هو الانقسام يدفع بمصطلحات من قبيل "الشعب الغزي" أو "الشعب الضفاوي" للظهور في سياقات ينبغي التعبير فيها عن الكل بدل الجزء.
أما ثالث المخاطر التي يجلبها استمرار الانقسام فهو توفير الانقسام فرصة تاريخية للعدو الصهيوني لتثبيت أركانه وتدعيم بنيانه لأجيال قادمة بسبب الوهن الفلسطيني الناجم عن الانقسام.
ورغم أن نظريات كثيرة تجزم بأن المشروع الصهيوني يحمل بذور فشله في داخله، وأنه سائر إلى زوال، لاستحالة نجاح أي استعمار إحلالي في البقاء في ظل فشله باستئصال وتصفية السكان الأصليين كما في حالتي جنوب إفريقيا والجزائر. إلا أن هذا لا يعني إمكانية إجهاض هذا المشروع في ظل واقع فلسطيني ضعيف. فكما نجح الاستعمار الأبيض في جنوب إفريقيا في تثبيت أركان حكمه أربعة قرون -بسبب ضعف وتشرذم أصحاب الأرض الأصليين-فإن الاحتلال الصهيوني قد يستمر ويمتد لأجيال قادمة إن لم تجتمع كلمة الفلسطينيين ومن خلفهم ظهيرهم العربي والإسلامي على مواجهة هذا الاستعمار الصهيوني الإحلالي. ولعل في تذكر الإمارات الصليبية في المشرق العربي فائدة؛ فقد امتد عمر بعضها في الشام إلى قرابة القرنين، بينما نجح الاستعمار الأسباني بطرد العرب المسلمين من الأندلس إلى الأبد، ولم يتحقق ذلك إلا لضعف وتشرذم أهل الشام والأندلس.
ولئن كنا نؤمن بحتمية تحرير المسجد الأقصى المبارك وعودة فلسطين إلى حضن أمتها فهذا لا يعني بالضرورة أن من سيحررها هو هذا الجيل! فلكي ينالَ هذا الجيل شرف تحرير هذه الأرض المباركة فإن أولى المهام هي توحيد الصف ولم الشمل واجتماع الكلمة، وما المصالحة الوطنية الفلسطينية إلا خطوة أولى على هذا الطريق الطويل.
ومن المشاهد الملموسة أن سنوات الانقسام قد أتاحت للعدو الصهيوني فرصة ذهبية لتوسيع استيطانه في الضفة وتعزيز حصاره لغزة وتفعيل مشاريعه لتهويد القدس والمسجد الأقصى ومضاعفة جهوده لترحيل فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر ممارسات عنصرية قد لا يكون آخرها "مشروع برافر"، ومشروع تصنيف مسيحيي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 فئة غير عربية وغير فلسطينية داخل الكيان المحتل. كل هذه الممارسات والسياسات ساهمت في خلق واقع جديد على الأرض أضعف الجانب الفلسطيني -المفاوض والمقاوم على حد سواء -وما كان هذا ليتحقق لولا تمادي الانقسام الفلسطيني والتشرذم الوطني. ولنتأمل جيداً لو أن كثيرًا من تلك الجهود الإعلامية والسياسية والأمنية الفلسطينية التي بذلت داخليا لمواجهة الطرف الفلسطيني الآخر عبر سنوات الانقسام قد بذلت حصرا في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفقا لتوافق وطني، فأي حال كانت ستكون عليه قضيتنا الوطنية اليوم؟! بلا شك أنه كان سيكون واقعا أفضل مما نحن عليه الآن! فالواقع الذي عشناه عبر سني الانقسام شهد تبدد الكثير من الإنجازات الوطنية الكبرى -العسكرية والدبلوماسية والشعبية-بسبب ضعف التنسيق الوطني أو غيابه.
هذا الواقع المؤلم، بجعلنا نفكر بعمق بالأثر الكبير التي كانت ستحققه إنجازات وطنية -حصلت في عهد الانقسام -لمشروعنا الوطني مثل صفقة وفاء الأحرار، والصمود في معركتي الفرقان والسجيل، والحصول على اعتراف أممي بفلسطين، والنجاح في إجهاض مشروع برافر، لو كان الصف الوطني موحدا؟! لقد كانت هذه الإنجازات الوطنية الكبرى إضافات نوعيه للنضال الفلسطيني، ولكنها كانت ستضيف أكثر لو أنها جرت في ظل توافق وطني.
أما رابع الآثار السلبية للاتقسام فهو استمرار خسارة القضية الفلسطينية لكم هائل من الدعم الدولي والإقليمي، الرسمي والشعبي بسبب -أو ربما بذريعة- الانقسام!
تكمن المشكلة هنا -في ظل الانقسام-بواقع تفرق وتشتت هذا الدعم الخارجي، فبدل أن يصب في صلب مشروع وطني موحد واضح المعالم يعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني، فإنه يصب في كل الاتجاهات، مما يؤخر من تحويل النضال الفلسطيني إلى سيل عرم متدفق متصل قادر على استئصال شأفة الاحتلال الصهيوني مرة وللأبد. أليس من حقائق الفيزياء أن ضغط السائل إن توزع ضعف أثره، وإن تركز في بؤرة واحدة اشتد أثره وعظم فعله؟
إن تحقيق توافق وطني فلسطيني على مشروع وطني موحد واضح المعالم سيجعل من أي موقف سياسي داعم أو مبلغ مالي مساند أو مشروع شعبي مؤيد، سيجعل منهم أضعافا مضاعفة بإذن الله تشد عضد الشعب الفلسطيني في نضاله وتؤثر على مراكز القوى في العالم بأسره لإيقاف جريمة الاحتلال وإعادة الحق الفلسطيني السليب.
يذكر "إيلان بابه" أحد أهم المؤرخين "الإسرائيليين" الجدد في كتابه المهم "التطهير العرقي في فلسطين" أن العصابات الصهيونية نجحت في إقامة كيانها المحتل على الأرض الفلسطينية عبر عمليات تطهير عرقي منظمة فشل الفلسطينيون ومن ساندهم من العرب -آنذاك-في إيقافها والدفاع عن وجودهم على أرضهم. ويشير إلى أن أحد أهم أسباب العجز الفلسطيني آنذاك كان ضعف بل وغياب القيادة، حيث نجح الانتداب البريطاني -الخائن-بضرب الحركة الوطنية الفلسطينية التي استنزفتها ثورة 1936 مما سهل على الميليشيات الصهيونية، الأكثر تنظيما والأفضل تسليحا وتدريبا، أن تبني كيانها على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية، ويعبر عن هذا الحال بقوله: "كان المجتمع الفلسطيني -من جميع النواحي-شعبا بلا قيادة!".
أما اليوم، وقد مضى على النكبة 66 عاما، وقد أصبح للشعب الفلسطيني فصائله ومؤسساته وقياداته وتاريخه النضالي العريق، فلا يصح أن ننتقل من أزمة غياب القيادة إلى أزمة انقسام القيادة! آن لشعبنا الفلسطيني أن يتوحد صفه القيادي وتعود مؤسساته الوطنية إلى تكثيف الجهود لتحرير الأرض والمقدسات ولعودة أصحاب الأرض الأصليين إلى ديارهم، وما لم يتم هذا التوحد؛ فأبشر -لا قدر الله- بطول سلامة يا احتلال!!
* تنويه: بعض أفكار هذا المقال مستقاة من كتاب "إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية" لجميل هلال.



























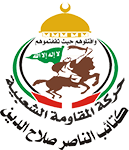
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية