نتائج انتخابات جامعة بيرزيت.. الأسباب والدلالات
ساري عرابي
لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت أهمية خاصة، تتعلق لدى الكثيرين بالطابع الرمزي للجامعة، كجامعة ليبرالية أسستها أسرة مسيحية قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، فتحولت ولفترة طويلة إلى مركز جذب للطلبة من بقية مناطق الضفة الغربية والقدس، لقربها النسبي من بقية المناطق، ولسمعتها الأكاديمية المرافقة لحالة طلابية مرتفعة سياسيا ونضاليا، إن على مستوى السجال الداخلي، أو على مستوى المواجهة مع الاحتلال.
إلا أن الأهمية الفعلية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت تأتي من قدرتها المعقولة على قياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، في الضفة والقدس تحديدا، والكشف عن التحولات المكتومة في قلب هذه الساحة الكبيرة.
في السنوات الثماني الأخيرة، لم تعد الانتخابات الطلابية في الضفة الغربية تملك القدرة ذاتها على قياس اتجاهات الرأي العام، بعدما استغرقها التراجع العام المنبثق عن حالة سياسية سحبت الاهتمام الوطني من الجمهور، متوسلة بأدوات اقتصادية وثقافية وأمنية لإعادة صياغة الوعي، وخلق بيئة لانشغالات تناقض بالضرورة الوظيفة النضالية لشعب يعاني من الاحتلال، وفرض أجندة جديدة يتقدم فيها الهم الفردي والأولويات المعيشية.
وامتد ذلك إلى عمق البنية الجامعية، بإعادة تشكيلها وإدخالها في هذه الحالة السياسية، ولم تكن الحركة الطلابية بمنأى عن التأثر بالحالة المجتمعية، ولا عن أدوات الإخضاع والسيطرة، إلا أن جامعة بيرزيت احتفظت إلى حد ما بقدر من الاستقلالية يتفوق على مثيلاتها من جامعات الضفة بما وفر لانتخاباتها الطلابية قدرة معقولة على قياس المزاج الشعبي في الضفة والقدس.
تتسم نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بثبات نسبي يظهر بالنتائج السنوية المعتادة التي تمنح كلا من الكتلتين الرئيسيتين فوزا يتراوح ما بين 19 مقعدا حدا أدنى من النادر أن تهبط عنه أي منهما، و23 مقعدا حدا أقصى من النادر أن ترتفع عنه أي منهما، من أصل 51 مقعدا، وذلك حتى في أسوأ الظروف التي مرت بها كل من الكتلتين.
وهذا يعني أن فتح وحماس مجتمعتين تحظيان بتأييد أكثر من 82 بالمئة من الجمهور الفلسطيني، وتتنافسان على نسبة من الأصوات العائمة غير المحسومة لأي منهما، بحيث يتأرجح التأييد الشعبي لكل منهما ما بين 37 إلى 45 ، بينما تعجز القوى الأخرى عن الاستفادة من تناقضات الحركتين الكبيرتين، أو من إخفاقاتهما وأزماتهما.
وهذه النتيجة الثابتة قريبة من نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت قبل تسع سنوات، بالنظر إلى نتائج القائمة النسبية (45،4 بالمئة لحماس، مقابل 40،9 بالمئة لفتح) لا إلى نتائج انتخابات الدوائر (69،7 بالمئة لحماس مقابل 24،2 بالمئة لفتح)، وهو ما يدل على أن الاختيار على أساس حزبي يختلف عنه على أساس فردي.
فوز هذا العام للكتلة الإسلامية كان مختلفا، بحصولها على 26 مقعدا لأول مرة في تاريخها، أي ما يكافئ 51 بالمئة من مجموع الأصوات، بينما حصلت كتلة فتح على 19 مقعدا، وكتل اليسار على 6 مقاعد فقط، في حين لم تشارك الكتلة المحسوبة على حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يكفي لجعل انتخابات هذا العام مختلفة تماما عن أي انتخابات سابقة، وللتعامل الحذر معها، فهذه القفزة الكبيرة للكتلة المحسوبة على حماس لا يمكن التعويل عليها ما لم تتكرر في السنوات القادمة.
ما كان لافتا أيضا في انتخابات هذا العام، هو فوز الكتلة الإسلامية، في حالة نادرة، بأصوات الطلبة الجدد بفارق ضئيل عن كتلة حركة فتح. فالغالب أن تصوت هذه الشريحة لكتلة فتح، ثم تتحول في السنوات التالية إلى التصويت لكتلة حماس، في دلالة مزدوجة على عدم قدرة حماس على الوصول إلى هذه الشريحة قبل الجامعة، وعلى عزوف الطالب عن فتح بعد تجريبها، وعلى جاذبية الأداء النقابي للكتلة الإسلامية.
هنا تجدر الإشارة إلى أن حماس حركة محظورة في القوانين الإسرائيلية وفي الواقع، بما يقلص من قدرتها على النشاط في المجال العام، وهذا الحظر تعزز من بعد الانقسام في العام 2007، حتى انعدمت مساحات تحركها في المجال العام تماما، وبالتالي، فالاقتراب منها سيكون مخيفا للكثيرين ممن يخشون على أمنهم ومصالحهم، فالمنافسة من هذه الجهة غير متكافئة بطبيعة الحال، وبالرغم من ذلك فإنها أولا تمكنت من الاحتفاظ برصيدها الجماهيري الأساسي، وثانيا من الوصول بدعايتها إلى شريحة لا تنجح في الوصول إليها عادة على نحو مرضٍ.
ثمة تطور أساسي، إذن، أدخل حماس إلى الشرائح المجتمعية كافة، بالرغم من حظر نشاطها في المجال العام. في حين أن أزمات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية غير كافية وحدها لتحقيق هذه القفزة، وإنما هي من ضمن العوامل المساعدة على التأثير في نتائج الانتخابات، ولم يكن خلال العام الماضي من تطورات كافية للقفز بحماس إلى هذا المستوى سوى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي يمكن اعتبارها "معركة كرامة جديدة"، مع الفارق بطبيعة الحال بين المعركتين زمانا ومكانا وموضوعا .
لقد كان الأداء القتالي المبهر لكتائب القسام، الذي عكس توظيف حماس لمقدراتها وحكومتها لأجل بناء وإعداد مقاومة كفؤة، هو العامل الحاسم في تحقيق هذه القفزة، وليس مجرد خوض الحرب.
وإذن، فإن الإيديولوجية الضمنية للشعب الفلسطيني لا تزال هي الكفاح المسلح، فأسبقية فتح إلى الكفاح المسلح في العام 1965، ثم استئنافها هذا الكفاح بعد هزيمة العام 1967، وخوضها لمعركة الكرامة في آذار 1968، وتصدرها الثورة الفلسطينية حتى الخروج من بيروت في العام 1982، وانخراطها الفاعل في الانتفاضة الأولى، ومشاركة قطاعات منها في الانتفاضة الثانية، دون أن تتبنى أي إيديولوجيا غريبة عن روح الشعب، حافظ على حضورها الشعبي والجماهيري طوال هذه الفترة الممتدة. لكنها الآن تستند فقط إلى عامل القوة المتمثل بالسلطة وما تمثله من ضمانات استقرار ومصالح اقتصادية.
أما حماس، فهي التي أعادت جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية إلى قلب التاريخ، بعدما كادت أن تخرج منه، لتصعد من جديد بعاملين أساسين: الكفاح المسلح، والخطاب الإسلامي المنبثق عن النموذج الثقافي المهيمن، أو المعنى الكلي السائد في المنطقة العربية، بما فيها فلسطين.
واللافت في هذا السياق أن تأتي هذه النتائج في ظل حملة إقليمية ودولية تهدف إلى اجتثاث الحركة الإسلامية، وتبشر بانتهاء ما يسمى بـ "الإسلام السياسي". الاستناد إلى هذين العاملين وما يتطلبانه من صدقية، ومسلكية جهادية نقية، وخدمة وتواضع للناس والتصاق بهم، هو ضمانة الاستمرار والنجاح في ظرف إقليمي وفلسطيني متغير وشديد التحول، لا يمكن فيه ضمان استمرار عامل القوة المستندة إلى السلطة والحكم.
صوت أبي عبيدة، وملامح محمد الضيف، والصواريخ التي دكت القدس وتل أبيب، ومعارك الأنفاق والخنادق والبحر والجو والإنزال خلف خطوط العدو وأسر الجنود، والصمود الأسطوري في شريط ضيق ومحاصر يفتقر إلى قوى الارتكاز والإسناد، والمعجزات التي اجترحت في هذا العدم؛ أدخل حماس بيوت جميع الفلسطينيين، وعرّف بها الأطفال وطلاب الثانويات.
لكن هل تنجح حماس في الحفاظ على ما اكتسبته من الحرب والمراكمة عليه؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
بالطبع لم يكن هذا العامل الحاسم هو العامل الوحيد، فثمة تقديرات بأن أصوات الطلاب من القدس من حملة الهويات الزرقاء، والمتحررين من إكراهات السلطة الأمنية والاقتصادية، قد صوتوا للكتلة الإسلامية، لكن تصويتهم هذا يعزز السؤال الأساسي عن سبب تصويتهم للكتلة الإسلامية تحديدا دون القوى الأخرى؟! لماذا لم يستفد اليسار وبقية القوى من صراع حماس وفتح، ومن أزمات الحركتين الكبيرتين؟ والسؤال ذاته يبقى قائما بخصوص التصويت العقابي، فمن عاقب فتح على خطابها أو سلوكها أو على أزمات السلطة السياسية والاقتصادية، لماذا لم يتجه بأصواته إلى طرف ثالث؟!
لقد كانت السنوات الثماني الماضية كافية لإنهاء آثار أحداث 2007 في غزة على صورة حماس لدى الشارع الضفاوي، وساهمت مظلومية ناشطي الكتلة الملاحقين في جلب التعاطف معهم، كما ساهم إصرارهم على مواصلة العمل والنشاط بالرغم من كل الظروف القاسية، في الوصول إلى هذه النتيجة، وهذه كلها أسباب هامة، فلولا من ناضل لخوض الانتخابات لما ظهرت نتائج حرب غزة في جامعة بيرزيت.
ساري عرابي
لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت أهمية خاصة، تتعلق لدى الكثيرين بالطابع الرمزي للجامعة، كجامعة ليبرالية أسستها أسرة مسيحية قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، فتحولت ولفترة طويلة إلى مركز جذب للطلبة من بقية مناطق الضفة الغربية والقدس، لقربها النسبي من بقية المناطق، ولسمعتها الأكاديمية المرافقة لحالة طلابية مرتفعة سياسيا ونضاليا، إن على مستوى السجال الداخلي، أو على مستوى المواجهة مع الاحتلال.
إلا أن الأهمية الفعلية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت تأتي من قدرتها المعقولة على قياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، في الضفة والقدس تحديدا، والكشف عن التحولات المكتومة في قلب هذه الساحة الكبيرة.
في السنوات الثماني الأخيرة، لم تعد الانتخابات الطلابية في الضفة الغربية تملك القدرة ذاتها على قياس اتجاهات الرأي العام، بعدما استغرقها التراجع العام المنبثق عن حالة سياسية سحبت الاهتمام الوطني من الجمهور، متوسلة بأدوات اقتصادية وثقافية وأمنية لإعادة صياغة الوعي، وخلق بيئة لانشغالات تناقض بالضرورة الوظيفة النضالية لشعب يعاني من الاحتلال، وفرض أجندة جديدة يتقدم فيها الهم الفردي والأولويات المعيشية.
وامتد ذلك إلى عمق البنية الجامعية، بإعادة تشكيلها وإدخالها في هذه الحالة السياسية، ولم تكن الحركة الطلابية بمنأى عن التأثر بالحالة المجتمعية، ولا عن أدوات الإخضاع والسيطرة، إلا أن جامعة بيرزيت احتفظت إلى حد ما بقدر من الاستقلالية يتفوق على مثيلاتها من جامعات الضفة بما وفر لانتخاباتها الطلابية قدرة معقولة على قياس المزاج الشعبي في الضفة والقدس.
تتسم نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بثبات نسبي يظهر بالنتائج السنوية المعتادة التي تمنح كلا من الكتلتين الرئيسيتين فوزا يتراوح ما بين 19 مقعدا حدا أدنى من النادر أن تهبط عنه أي منهما، و23 مقعدا حدا أقصى من النادر أن ترتفع عنه أي منهما، من أصل 51 مقعدا، وذلك حتى في أسوأ الظروف التي مرت بها كل من الكتلتين.
وهذا يعني أن فتح وحماس مجتمعتين تحظيان بتأييد أكثر من 82 بالمئة من الجمهور الفلسطيني، وتتنافسان على نسبة من الأصوات العائمة غير المحسومة لأي منهما، بحيث يتأرجح التأييد الشعبي لكل منهما ما بين 37 إلى 45 ، بينما تعجز القوى الأخرى عن الاستفادة من تناقضات الحركتين الكبيرتين، أو من إخفاقاتهما وأزماتهما.
وهذه النتيجة الثابتة قريبة من نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت قبل تسع سنوات، بالنظر إلى نتائج القائمة النسبية (45،4 بالمئة لحماس، مقابل 40،9 بالمئة لفتح) لا إلى نتائج انتخابات الدوائر (69،7 بالمئة لحماس مقابل 24،2 بالمئة لفتح)، وهو ما يدل على أن الاختيار على أساس حزبي يختلف عنه على أساس فردي.
فوز هذا العام للكتلة الإسلامية كان مختلفا، بحصولها على 26 مقعدا لأول مرة في تاريخها، أي ما يكافئ 51 بالمئة من مجموع الأصوات، بينما حصلت كتلة فتح على 19 مقعدا، وكتل اليسار على 6 مقاعد فقط، في حين لم تشارك الكتلة المحسوبة على حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يكفي لجعل انتخابات هذا العام مختلفة تماما عن أي انتخابات سابقة، وللتعامل الحذر معها، فهذه القفزة الكبيرة للكتلة المحسوبة على حماس لا يمكن التعويل عليها ما لم تتكرر في السنوات القادمة.
ما كان لافتا أيضا في انتخابات هذا العام، هو فوز الكتلة الإسلامية، في حالة نادرة، بأصوات الطلبة الجدد بفارق ضئيل عن كتلة حركة فتح. فالغالب أن تصوت هذه الشريحة لكتلة فتح، ثم تتحول في السنوات التالية إلى التصويت لكتلة حماس، في دلالة مزدوجة على عدم قدرة حماس على الوصول إلى هذه الشريحة قبل الجامعة، وعلى عزوف الطالب عن فتح بعد تجريبها، وعلى جاذبية الأداء النقابي للكتلة الإسلامية.
هنا تجدر الإشارة إلى أن حماس حركة محظورة في القوانين الإسرائيلية وفي الواقع، بما يقلص من قدرتها على النشاط في المجال العام، وهذا الحظر تعزز من بعد الانقسام في العام 2007، حتى انعدمت مساحات تحركها في المجال العام تماما، وبالتالي، فالاقتراب منها سيكون مخيفا للكثيرين ممن يخشون على أمنهم ومصالحهم، فالمنافسة من هذه الجهة غير متكافئة بطبيعة الحال، وبالرغم من ذلك فإنها أولا تمكنت من الاحتفاظ برصيدها الجماهيري الأساسي، وثانيا من الوصول بدعايتها إلى شريحة لا تنجح في الوصول إليها عادة على نحو مرضٍ.
ثمة تطور أساسي، إذن، أدخل حماس إلى الشرائح المجتمعية كافة، بالرغم من حظر نشاطها في المجال العام. في حين أن أزمات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية غير كافية وحدها لتحقيق هذه القفزة، وإنما هي من ضمن العوامل المساعدة على التأثير في نتائج الانتخابات، ولم يكن خلال العام الماضي من تطورات كافية للقفز بحماس إلى هذا المستوى سوى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي يمكن اعتبارها "معركة كرامة جديدة"، مع الفارق بطبيعة الحال بين المعركتين زمانا ومكانا وموضوعا .
لقد كان الأداء القتالي المبهر لكتائب القسام، الذي عكس توظيف حماس لمقدراتها وحكومتها لأجل بناء وإعداد مقاومة كفؤة، هو العامل الحاسم في تحقيق هذه القفزة، وليس مجرد خوض الحرب.
وإذن، فإن الإيديولوجية الضمنية للشعب الفلسطيني لا تزال هي الكفاح المسلح، فأسبقية فتح إلى الكفاح المسلح في العام 1965، ثم استئنافها هذا الكفاح بعد هزيمة العام 1967، وخوضها لمعركة الكرامة في آذار 1968، وتصدرها الثورة الفلسطينية حتى الخروج من بيروت في العام 1982، وانخراطها الفاعل في الانتفاضة الأولى، ومشاركة قطاعات منها في الانتفاضة الثانية، دون أن تتبنى أي إيديولوجيا غريبة عن روح الشعب، حافظ على حضورها الشعبي والجماهيري طوال هذه الفترة الممتدة. لكنها الآن تستند فقط إلى عامل القوة المتمثل بالسلطة وما تمثله من ضمانات استقرار ومصالح اقتصادية.
أما حماس، فهي التي أعادت جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية إلى قلب التاريخ، بعدما كادت أن تخرج منه، لتصعد من جديد بعاملين أساسين: الكفاح المسلح، والخطاب الإسلامي المنبثق عن النموذج الثقافي المهيمن، أو المعنى الكلي السائد في المنطقة العربية، بما فيها فلسطين.
واللافت في هذا السياق أن تأتي هذه النتائج في ظل حملة إقليمية ودولية تهدف إلى اجتثاث الحركة الإسلامية، وتبشر بانتهاء ما يسمى بـ "الإسلام السياسي". الاستناد إلى هذين العاملين وما يتطلبانه من صدقية، ومسلكية جهادية نقية، وخدمة وتواضع للناس والتصاق بهم، هو ضمانة الاستمرار والنجاح في ظرف إقليمي وفلسطيني متغير وشديد التحول، لا يمكن فيه ضمان استمرار عامل القوة المستندة إلى السلطة والحكم.
صوت أبي عبيدة، وملامح محمد الضيف، والصواريخ التي دكت القدس وتل أبيب، ومعارك الأنفاق والخنادق والبحر والجو والإنزال خلف خطوط العدو وأسر الجنود، والصمود الأسطوري في شريط ضيق ومحاصر يفتقر إلى قوى الارتكاز والإسناد، والمعجزات التي اجترحت في هذا العدم؛ أدخل حماس بيوت جميع الفلسطينيين، وعرّف بها الأطفال وطلاب الثانويات.
لكن هل تنجح حماس في الحفاظ على ما اكتسبته من الحرب والمراكمة عليه؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
بالطبع لم يكن هذا العامل الحاسم هو العامل الوحيد، فثمة تقديرات بأن أصوات الطلاب من القدس من حملة الهويات الزرقاء، والمتحررين من إكراهات السلطة الأمنية والاقتصادية، قد صوتوا للكتلة الإسلامية، لكن تصويتهم هذا يعزز السؤال الأساسي عن سبب تصويتهم للكتلة الإسلامية تحديدا دون القوى الأخرى؟! لماذا لم يستفد اليسار وبقية القوى من صراع حماس وفتح، ومن أزمات الحركتين الكبيرتين؟ والسؤال ذاته يبقى قائما بخصوص التصويت العقابي، فمن عاقب فتح على خطابها أو سلوكها أو على أزمات السلطة السياسية والاقتصادية، لماذا لم يتجه بأصواته إلى طرف ثالث؟!
لقد كانت السنوات الثماني الماضية كافية لإنهاء آثار أحداث 2007 في غزة على صورة حماس لدى الشارع الضفاوي، وساهمت مظلومية ناشطي الكتلة الملاحقين في جلب التعاطف معهم، كما ساهم إصرارهم على مواصلة العمل والنشاط بالرغم من كل الظروف القاسية، في الوصول إلى هذه النتيجة، وهذه كلها أسباب هامة، فلولا من ناضل لخوض الانتخابات لما ظهرت نتائج حرب غزة في جامعة بيرزيت.



























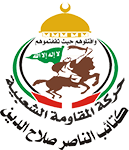
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية